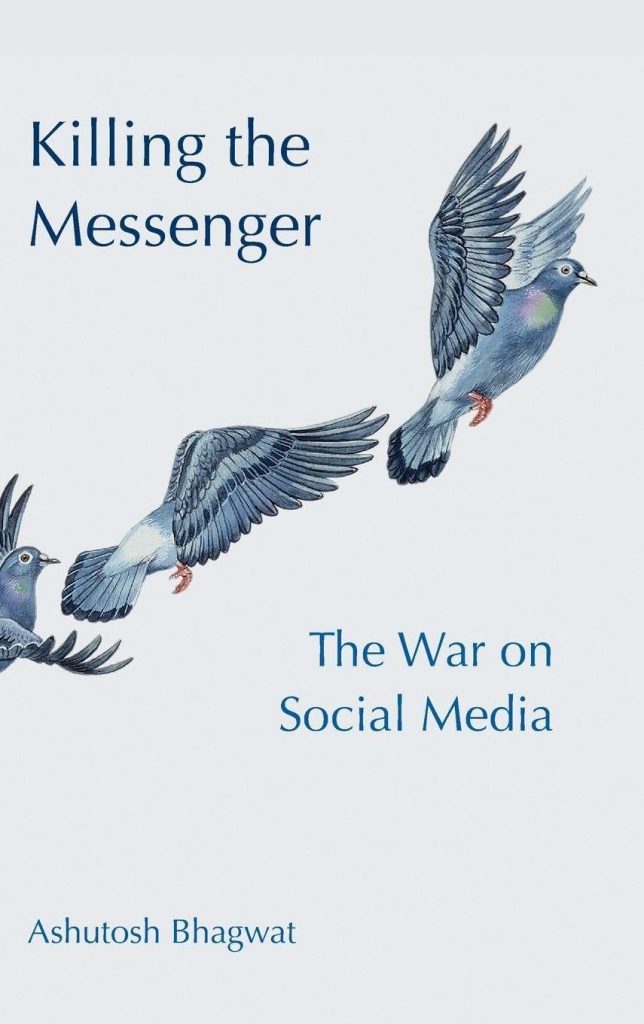صدر اليوم كتاب مهم عن مطبوعات جامعة كامبردج Cambridge University Press لإستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا أشوتوش بهاجوات Ashutosh Bhagwat، بعنوان:
قتل الرسول: الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي
Killing the Messenger : The War on Social Media
الكتاب دراسةً شاملةً للحروب السياسية والقانونية الدائرة حاليًا على منصات التواصل الاجتماعي، ويستعرض بعمق الجدل السياسي والقانوني الدائر حول هذه المنصات ، ويعتبرها مرآة تعكس واقعنا الاجتماعي والسياسي المعاصر. ينتقد المؤلفُ التصورات السلبية والمتطرفة المنتشرة بين الساسة والإعلاميين بشأن أثر وسائل التواصل، مبيناً أن كثيراً من مشاكل المجتمع المنسوبة لهذه المنصات – مثل الاستقطاب السياسي والمشاكل النفسية لدى المراهقين – لها جذور تاريخية سابقة على ظهورها، وأن مسؤولية الإعلام التقليدي والسياسيين في تضخيم تلك المشاكل كبيرة لأنهم خسروا احتكارهم للمعلومات والنقاش العام.
ويؤكد المؤلف أن وسائل التواصل الاجتماعي أقرت “ديمقراطية الخطاب”، عبر تمكين شرائح أوسع من الجمهور من إيصال أصواتهم دون رقابة من نخب إعلامية وسياسية، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأن ثمة آثاراً سلبية كالتلاعب بالمعلومات، الخطاب الكراهية، وانتهاك الخصوصية،وأن كثيراً من مناقشات الضرر بشأن التواصل الاجتماعي، تضخم وتبالغ في حجم المشكلة، وغالباً ما تفتقد الأساس التجريبي الموثوق.
كما يُحلل العمل اللوائح المُوجهة إلى منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعديل المادة 230 من قانون آداب الاتصالات. ويجادل المؤلف بأن العديد من هذه المقترحات لا تُثير مخاوف جدية بشأن حرية التعبير فحسب، بل يُحتمل أيضًا أن يكون لها عواقب غير مقصودة وضارة على السياسة العامة.
– ويتناول بشكل معمق العلاقة الملتبسة والمعقدة بين خصوصية البيانات الضخمة وحرية التعبير، مع التركيز على الإشكاليات التشريعية والأخلاقية التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي في العصر الرقمي.يؤكد المؤلف أن جمع ومعالجة بيانات المستخدمين، أمرٌ لا غنى عنه لتشغيل منصات التواصل الاجتماعي الحديثة، فالحجم الهائل للمحتوى يتطلب خوارزميات لاقتراح المحتوى والإعلانات بشكل شخصي وفعّال، مما يجعل الخصوصية موضوعاً محورياً لا يمكن تجاوزه.
يعتمد نموذج الأعمال الأساسي لهذه المنصات على الإعلانات المستهدفة، والتي تتطلب بيانات دقيقة عن تفضيلات وسلوكيات المستخدمين. وأي محاولة لتقييد هذا الأمر إما تخفض من جودة الخدمة وتجربة المستخدم، أو تدفع المنصات لاعتماد نموذج الاشتراكات المدفوعة، وهو ما رفضه أغلب المستخدمين عند اختباره في أوروبا.
يفرد المؤلف مساحة لمناقشة التشريعات الأوروبية :اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR والأمريكية قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا CCPA ، موضحاً أنّ التشريعات الأوروبية تمنح حقوقاً أوسع للفرد بشأن بياناته، بينما الأمريكية تظل أكثر انحيازاً إلى حرية السوق. تعالج اللائحة العامة لحماية البيانات ستة أسباب قانونية، لمعالجة البيانات منها مصلحة الطرف المسيطر، لكنه أيضاً يفتح باباً واسعاً للسلطات التنظيمية، لفرض مزيد من القيود غير المتوقعة على المنصات.
كمايعرض المؤلف تنظيراً تمييزياً بين خصوصية البيانات، سيطرة الفرد على كيفية تخزين ومعالجة بياناته، وخصوصية الكرامة، حماية الحق في عدم نشر أو فضح وقائع شخصية محرجة، ويشير أن قوانين كاللائحة العامة لحماية البيانات مزجت بين المفهومين، مما أربك الأمور في تطبيق حقوق مثل “الحق في النسيان” خاصة في قضايا مثل Google Spain الشهيرة.
يناقش المؤلف آثار التنظيمات الصارمة على حرية التعبير: فالقوانين التي تفرض قيوداً على مشاركة البيانات أو الحق في محوها، قد تتحول إلى نوع من الرقابة أو تقييد حرية تداول المعلومات، خصوصاً إذا تعلّق الأمر بشخصيات عامة أو مواضيع تهم المجال العام. ويرى المؤلف أن التشدد في التشريعات قد يعزز الاحتكار، لأن المنصات الكبرى وحدها قادرة على تحمّل أعباء الامتثال، ما يصعّب دخول منافسين جدد.
ويطرح سؤال محوري: هل البيانات خطاب محمي بموجب حرية التعبير؟ ويشير إلى أن المحكمة العليا الأمريكية تلميحاً أيدت أن البيانات “خطاب”، وعليه فإن أي تنظيم للبيانات لا بد أن يراعي هذا الحق، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يُعتَبر فرض الحق في النسيان على غرار أوروبا غير دستوري بالنسبة للقانون الأمريكي.
يخصص جزءاً لمناقشة الحماية الخاصة للأطفال، إذ توجد تشريعات أمريكية وأوروبية أكثر تشدداً، مثل حظر الإعلانات المستهدفة للقاصرين في أوروبا وقوانين التحقق من العمر. إلا أن هذه القوانين تواجه تحديات دستورية في الولايات المتحدة تحت مظلة التعديل الأول.
يبين المؤلف أن تطبيق إجراءات حماية البيانات باهظة الكلفة، ويشكل عبئاً كبيراً على الشركات الصغيرة، وهو ما قد يؤدي إلى إحتكار السوق من قبل الكبار. كما يشير إلى أن الدراسات الميدانية أظهرت أن قلة قليلة من المستخدمين يفعّلون فعليًا حقوقهم في الاطلاع أو حذف بياناتهم، ما يطرح تساؤلات عملية حول فعالية مثل هذه الحقوق.
يدعو المؤلف إلى الحذر وأن يكون التشريع مرناً وقابلاً للمراجعة الدائمة، وأن يتجنب المبالغة في فرض القيود، خاصة في مجال تقني شديد التطور والتغير كالمنصات الرقمية، ليكون التشريع واقعيًا ومتوازناً بين حماية الخصوصية وعدم التضحية بالحيوية الديمقراطية وحرية التعبير.
ويطرح رؤى للسياسات العملية والحدود التي يجب أن تحكم علاقة المجتمع والقانون بالتقنيات الرقمية الجديدة،يركز على كيفية إيجاد مقاربة متزنة وعملية تنظم وسائل التواصل الاجتماعي، دون التضحية بقيم الديمقراطية وحرية التعبير.
ينطلق من أن أغلب الاقتراحات التنظيمية الصادرة عن الجهات السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا، إما مبالغ فيها أو قائمة على فهم ناقص لأثر وسائل التواصل، وأن التنظيم الفعّال يجب أن يستند فقط إلى أضرار مثبتة بوضوح، وليس إلى افتراضات أو ذعر أخلاقي.
ومن أهم التوصيات والحلول المقترحة:
-سياسة “لا ضرر أولاً: أي تدخل تنظيمي يجب أن يكون موجهاً حصرياً، نحو معالجة الأضرار المثبتة والمحددة، مثل الأذى المادي المباشر كحماية الأطفال من الاستغلال، أو وقف الحملات الإجرامية المنظمة، وأن تُستثنى الاتهامات غير المثبتة بالتأثير السلبي، على الصحة النفسية أو الاستقطاب السياسي من التدخل القانوني الصارم.
-الحذر من التضحية بحرية التعبير: يدعو المؤلف إلى مقاومة التوسع في تنظيم الخطاب الرقمي الذي قد يعيق النقاش العام أو يستغل سياسياً لقمع الآراء المعارضة، وينتقد محاولات تحويل المنصات الرقمية إلى “ناقل عام” يخضع لقواعد رقابية حكومية أو تفرض عليه الحياد الإجباري، لأنها تلغي التنوع الطبيعي الذي يجلبه التحول الرقمي.
-أولوية الإصلاح الذاتي والممارسات الشفافة: يشجع المؤلف المنصات التقنية على تطوير أدوات وضوابط ذاتية فعالة كالشفافية في السياسة التحريرية، وآليات الشكوى، والتوضيح العلني للمعايير والتحديث المستمر للأنظمة، مع ترك مساحة تنافسية دون احتكار لتعزز هذه الحلول من نفسها عبر السوق.
-حدود التنظيم وأهم المحاذير
ينتقد المؤلف الاتجاه لإعفاء المنظمات الحكومية من عبء إثبات الضرر الفعلي قبل فرض القوانين؛ ويشدد على أن التنظيم المبالغ قد يقوي أكبر الشركات فقط، لأنها الوحيدة القادرة على تحمل الأعباء القانونية والتقنية، ما يؤدي عملياً إلى قتل المنافسة والابتكار. كما ينبه إلى أن الكثير من المقترحات الحالية ،تعيد إنتاج أخطاء تاريخية رافقت كل ثورة تكنولوجية، وتمثل نوعاً من “الذعر الأخلاقي” الاجتماعي لا يساعد في فهم تأثيرات التقنية الواقعية.
-تشدد الكاتب بشأن المستقبل
يختم المؤلف بتوجيه دعوة لقبول عدم اليقين وإستيعاب الثورة الرقمية، بمزيد من المرونة القانونية والانفتاح على التجربة، رافضاً التصورات الحتمية عن أثر وسائل التواصل أو محاولة إعادة “العصر الذهبي” للإعلام التقليدي عبر التشريعات.
في النهاية، يصرّ المؤلف أن أي تنظيم عملي لمجال وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن يكون قابلاً للتعديل السريع، مع تركيز مستمر على حماية حرية التعبير والمنافسة، وعدم التصدي للأوهام أو الذعر الجماعي بل الاعتماد على الأدلة والمرونة وفتح الباب أمام الحلول الذاتية والتجريبية.