سيصدر في نهاية هذا الشهر كتاب مهم ، عن منشورات London Publishing Partnership للخبيرة في التجارة الرقمية والمستدامة وسلاسل التوريد ريبيكا هاردينغ Rebecca Harding
تحت عنوان:
العالم في حرب اقتصادية: كيف نعيد بناء الأمن في اقتصاد عالمي مُسلّح،
The World at Economic War: How to Rebuild Security in a Weaponized Global Economy
يتناول هذا الكتاب دور الاقتصاد في الحروب الحديثة،ويُجادل بأنّ الاقتصاد نفسه في حالة حرب، فمؤسسات النظام الاقتصادي لما بعد الحرب مُمزّقة بتحديات تُهدّد شرعيتها، مما يجعل اليقينيات القديمة للاقتصاد القائم على السوق، في أحسن الأحوال، موضع نزاع، وفي أسوأها، بلا جدوى.
يُبيّن الكتاب كيف أصبح نظام السوق نفسه، من خلال ترابطات العولمة، وسيلةً لـ”صراع القوى العظمى”، مُسرّعًا بفعل الوتيرة السريعة لرقمنة الخدمات المالية. يتسرب هذا الصراع الاقتصادي إلى طريقة عمل التجارة الدولية، وكيفية إجراء المدفوعات عبر الحدود، وسلاسل التوريد، وحتى إلى كيفية تحكّم الأسواق المالية في قدرة الحكومات على إدارة سياسات الاقتصاد الكلي.
لم تعد المؤسسات التي بُنيت للتعامل مع اقتصاد زمن السلم كافيةً في ظلّ الصراع العسكري في أوروبا والشرق الأوسط، وتصاعد التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. بدا الإنفاق على الدفاع والأمن غير ذي أهمية في ظل العولمة، ولكن لأن العالم يمر الآن بحرب اقتصادية، فإن القدرة على بناء القدرات أو تمويل دفاعنا وأمننا محدودة.
الأمن العسكري والاقتصادي وجهان لعملة واحدة: كلاهما وسيلة لإبراز القوة؛ وكلاهما سياسي بامتياز؛ وكلاهما وسيلتنا للردع والدفاع والإكراه والمرونة.
ويجب أن نتحدث عن الحرب الاقتصادية بدلًا من مجرد حرب تجارية نظرًا للتهديد المنهجي للأطر المؤسسية والمالية في حقبة ما بعد الحرب.
يشرح الكتاب كيف نشأ هذا الوضع: جزئيًا بسبب الإهمال، وجزئيًا بسبب استخدام الأدوات التقليدية لإدارة شؤون الدولة الاقتصادية (العقوبات، وضوابط التصدير، والقيود المالية).
كما يتناول الكتاب أهمية هذا الأمر الآن، في سياق التهديدات العسكرية والاقتصادية المتزايدة لدفاعنا وأمننا.
كمايتناول دوافع الحرب الاقتصادية ووسائلها، والتهديدات التي تنطوي عليها، وكيف يمكن للدول تطوير “استراتيجيات تكيف” جيوستراتيجية للعالم المضطرب حديثًا. كما يصف كيف يمكن لتلك الدول التي تؤمن بالسوق والحريات الديمقراطية المرتبطة به، إنشاء مؤسسات وهياكل جديدة لضمان الأمن الاقتصادي واستدامة قيم المجتمع المدني.
يهدف الكتاب الى شرح كيف وصلنا إلى هنا ولماذا وجهات النظر التقليدية حول الحكم الاقتصادي غير كافية، بل وعكسية الإنتاج. و ما يمكننا فعله لضمان أمننا من خلال المؤسسات والعلاقات المالية الجديدة. يقدم الكتاب صورة لما قد يبدو عليه “الحكم الاقتصادي 2.0”.
يتجذر هذا الصراع الجديد بين القوى العظمى على الأمن القومي في الرغبة في السيطرة على اقتصادات القرن الحادي والعشرين، وأعماله، وأمواله، وبياناته، وتقنياته، بالإضافة إلى أدوات القوة في القرن العشرين : النفط والغاز.
وقد أصبح الاقتصاد وسيلة للسيطرة على هذا النموذج الجديد للقرن الحادي والعشرين.
ونظرًا لهذا التهديد المنهجي لطبيعة السوق الحرة ذاتها، والقيم الديمقراطية التي دعمت المؤسسات الأوروبية والعالمية، أصبحت البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية غير كافية – بل وربما عفا عليها الزمن،علما أن الاتحاد الأوروبي تأسس لمنع الحرب، من خلال تسخير التجارة والنمو الاقتصادي ،اللذين من شأنهما منع الاستياء الذي من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى الصراع،و تأسست منظمة التجارة العالمية على مبدأ مماثل ، وهو أن أنظمة التجارة المتعددة الأطراف ضرورية للسلام والاستقرار العالميين.
ومع ذلك، هناك الآن حرب على حدود أوروبا وكذلك في الشرق الأوسط، ولم يكن خطر الحرب الحركية (أي العسكرية) الناشئة عن شبكة معقدة من الحرب “المنطقة الرمادية” أو “دون العتبة” أو “الهجينة” ،والتي تستخدم أدوات غير عسكرية للقتال في الآونة الأخيرة.
-ما هي الحرب الاقتصادية؟
تُعرّف الحرب الاقتصادية هنا بأنها صراع بين الدول القومية، وبين الاقتصادات الوطنية وأنظمتها الاقتصادية. ورغم عدم وجود تعريف رسمي لها في الأدبيات، إلا أنها تُعتبر تقليديًا وسيلة للتأثير على قدرة الدولة على شن حرب عسكرية، وبالتالي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بإطار الدفاع والأمن.
ويشمل هذا الإطار تدفقات البيانات والأموال والخدمات اللوجستية في سلاسل التوريد الحديثة لتوصيل البضائع إلى خطوط المواجهة بأقصى قدر ممكن من المرونة والاستجابة.
وقد وصفت الحرب الاقتصادية أنها “جهود متزامنة بين القطاعين العام والخاص لدمج الأدوات الاقتصادية والقدرات العسكرية لتشكيل أداء منظومة الدفاع لتحقيق القوة العسكرية”.
وهي كذلك القدرة على استخدام الأدوات والتقنيات الاقتصادية لتعطيل سلاسل التوريد أو تقويض اقتصاد الخصم. أما الحرب التجارية، فهي نزاع اقتصادي بين دولتين ناتج عن سلوكيات إحداهما التي يُنظر إليها على أنها تضر بالأخرى.
قد تشمل هذه السلوكيات الإغراق (أو التجارة في السلع بأقل من قيمتها الطبيعية)، والحمائية (مثل التعريفات الجمركية أو الحصص التمييزية) أو السياسات التي تقوض شروط “تكافؤ الفرص” في التجارة الدولية، مثل الدعم الحكومي.
إن المعركة بين رأسمالية السوق الحرة من جه،ة والرأسمالية التي تديرها الدولة من جهة أخرى معروفة جيدًا. لكن التهديد يكمن في أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية التي حكمت حقبة ما بعد الحرب متورطة الآن في صراع أيضًا – صراع بين نماذج اقتصادية مختلفة ولكن أيضًا، كما يجادل مارتن وولف، صراع بين التعددية، التي بلغت ذروتها في العولمة، والقومية الاقتصادية الناشئة التي تهيمن الآن على منافسة القوى العظمى.
تتضمن هذه المعركة الاقتصادية من أجل السيطرة على أنظمة الحوكمة الاقتصادية التقنيات والبيانات والأنظمة المالية التي تحكم ليس فقط الدفاع والأمن ولكن أيضًا أمننا الاقتصادي.
يحدث هذا لأنه في الغرب، تم “إزالة الوساطة” عن الدولة القومية، أو استبدالها كهيكل مؤسسي منظم لمجتمع ما بعد الصناعة من خلال عملية العولمة. إن التدفق الحر للمعلومات والسلع والخدمات والتمويل والتكنولوجيا والأشخاص والبيانات عبر الحدود يعني شيئًا واحدًا: لقد خصصت الشركات العالمية والأسواق الحرة الموارد بطريقة لا تفيد قوة الدولة ونخبها السياسية.
على سبيل المثال، شركة أبل هي شركة أمريكية، لكنها تصنع في الصين، وبشكل متزايد في الهند؛ ولديها مركز ابتكار في كاليفورنيا، لكنها تحصل على مكونات سلاسل التوريد الخاصة بها من شبكة معقدة من الروابط في كوريا الجنوبية وتايوان والصين.
وهي تعتمد على شبكة متطورة من الخدمات اللوجستية والشحن في جميع أنحاء العالم لجعل النظام بأكمله يعمل بفعالية. يتم تكرار نموذج أعمال أبل عبر الصناعات. أصبحت السيارات والطائرات والأدوية وأجهزة الكمبيوتر والسلع المنزلية والأغذية والمطاعم والخدمات المالية – في الواقع كل شيء تقريبًا تم استهلاكه أو سهّل الاستهلاك – أعمالًا عالمية.
وبما أن اللوائح في البلدان الأخرى تملي الهياكل التنظيمية للشركات التابعة، يتم خلق فرص العمل ودفع الأجور وتطوير الابتكارات وتنويع الملكية.
طوال عملية العولمة لم يكن للحكومات رأي يذكر حول كيفية تطور نموذج الأعمال.و في ظل نموذج رأسمالية السوق، يقع واجب الشركة الائتماني على عاتق مساهميها، لا على عاتق الحكومة. ومع انقضاء ربع القرن الحادي والعشرين، يُمثل التوتر بين الدول القومية والشركات العالمية،وهوالتحدي الأبرز في الغرب.
يتضمن الكتاب ثمانية فصول ، يتناول الفصل الأول الإجابة على سؤال هل نحن في حالة حرب اقتصادية ؟
تؤكد الكاتبة بانه نظرًا لهشاشة النظام العالمي الراهنة، فقد حان الوقت للاعتراف بدور الاقتصاد ومناقشته صراحةً كوسيلة لإبراز القوة؛ وكوسيلة للتأثير على الخصوم وإكراههم؛ وفي نهاية المطاف، كوسيلة للانخراط في الصراع.
على مر التاريخ، لعب الاقتصاد دورًا مهمًا، إن لم يكن حاسمًا، في إبراز القوة من خلال التجارة وبناء الإمبراطوريات والإمبريالية الاقتصادية. الوضع الذي نواجهه الآن ليس استثناءً، ولا إبراز القوة الاقتصادية كذلك. فعندما بدأت الحرب الاقتصادية في الماضي، تبعتها حرب بالمعنى العسكري وهو تحريك الجيوش في الميادين و خوض المعارك للسيطرة على الارض .
ولفهم سبب وصولنا إلى هذه النقطة، يتناول الفصل الثاني صعود القومية الاقتصادية وفشل اقتصاديات السوق الحرة في تقديم حلول للمشاكل الوجودية التي يراها الناس من منظور أمنهم الاقتصادي وتغير المناخ وعدم المساواة.
يتناول الفصل الثالث كيفية تطور هذا من حيث عالم العقوبات وسلاسل التوريد المعقد الذي تطور منذ غزو روسيا لأوكرانيا، بدءًا من شرح التهديدات المادية للنظام الاقتصادي وكيفية التنافس عليها من خلال التجارة وسلاسل التوريد. وينظر إلى المدى الذي تحولت فيه “حكومتنا الاقتصادية” ضدنا أولاً من خلال السيطرة على السلع الأساسية ولكن أيضًا من خلال نظام المدفوعات وتمويل التجارة الذي يدعم سلاسل التوريد العالمية.
ويأخذ الفصل الرابع هذه الحجة إلى أبعد من ذلك من خلال النظر في الفصل المحتمل للعالم إلى مجالين: مجال البريكس الذي تهيمن عليه الصين وإحباطات روسيا من هياكل بريتون وودز الحالية؛ ومجال الولايات المتحدة الذي يقوض المؤسسات الدولية وينسحب منها مع وجود دولة بسيطة وتنظيم مخفف للسماح للأسواق الحرة للقطاع الخاص غير المقيدة بالعمل.
يأخذ الفصلان الخامس والسادس المناقشة إلى قدرة هياكلنا المؤسسية على توفير الدفاع والأمن والتكيف بمرونة عبر مجموعة التهديدات التكنولوجية التي نواجهها حاليًا.
يتناول الفصل السادس تحديدًا تلك التهديدات التي تواجه عمليات سلاسل التوريد والشبكات من منظور مالي. ويجادل بأن اكتشاف التهديدات أمر بالغ الصعوبة لأن رقمنة الأموال تعتمد على تقنيات ثابتة وفردية بدلًا من أن تكون مجمعة. لكن التحكم في هذه البيانات واستخدامها سيحدد طبيعة الحروب الاقتصادية في المستقبل مع انتشار العملات الرقمية والمدفوعات الرقمية على نطاق أوسع. على سبيل المثال، تستثمر كل من الصين والاتحاد الأوروبي مواردها في العملات الرقمية للبنوك المركزية التي لا تزال متجذرة في أداء الاقتصاد. في المقابل، تميل الولايات المتحدة نحو احتياطيات البيتكوين كوسيلة لخلق الأمن الاقتصادي.
يتناول الفصلان السابع و الثامن من الكتاب، مسألة كيفية التعامل مع هذه التهديدات – كيفية خلق الأمن الاقتصادي والمرونة. هناك ميل لدى الشركات والمؤسسات إلى اتباع نهج “العمل كالمعتاد حتى يصبح غير معتاد” تجاه كل ما يجري. من السهل كتابة قائمة شاملة بجميع التحديات التي قد تواجهها الشركة، ولكن من الأصعب وضع استراتيجيات يمكنها خلق نوع سلاسل التوريد والمرونة المؤسسية اللازمة.
يتخذ الفصل السابع نهجًا مختلفًا للنظر في هذا الأمر، حيث يطرح تحديًا استراتيجيًا كبيرًا ناجمًا عن تغير المناخ: الجغرافيا السياسية للدائرة القطبية الشمالية. ويستخدم أدلة من عشر جلسات حرب اقتصادية شارك فيها ما مجموعه 2500 شخص بين جوان 2023 وجانفي 2025 للنظر في طرق بديلة لمواجهة التحديات التي نواجهها.
تضمن الفصل الأخير تقييم مدى خطورة التهديد الحالي والمادي؟” لطالما كانت التهديدات موجودة، ولسنا بحاجة إلى أن نرى في هذه التهديدات حتمية الحروب العسكرية. تمتد هذه التهديدات عبر المجتمع المدني إلى نسيج حياتنا الاقتصادية اليومية. إلى البنى التحتية الاجتماعية الحيوية التي تحدد معايير وقيم الاقتصادات الديمقراطية. في الواقع، من الممكن القول بأن فترة السلام النسبي كانت بمثابة نقطة تحول.
كما يقدم هذا الفصل بعض التوصيات لإنشاء رادعات اقتصادية ذات مصداقية، بما في ذلك مؤسسات مالية ومصرفية متعددة الأطراف جديدة لخلق الدفاع والأمن والمرونة. والأهم من ذلك كله، نحن بحاجة إلى قيادة لغرس ذهنية التأهب في جميع أنحاء المجتمع المدني والبنى التحتية الاجتماعية الحيوية.
إن أطر الدفاع والأمن في جميع أنحاء العالم قائمة على هذا الأساس،
و من خلال الصمت بشأن التهديدات التي نواجهها، والتظاهر بأن كل شيء على ما يرام، فإن السياسيين يخاطرون بدفع الجمهور المرتبك إلى التطرف السياسي.
وأن الوسط الليبرالي يحتاج إلى تبني بعض اللغة الصريحة للتطرف الشعبوي.
إن خوض حربٍ اقتصادية لا يعني بالضرورة أننا في حربٍ عسكرية، ولكنه يعني أن الشركات ومؤسسات الخدمات المالية ستواجه خياراتٍ صعبةً لضمان الامن الاقتصادي والدفاع والأمن. وهذا هو تحدي عصرنا الحالي.
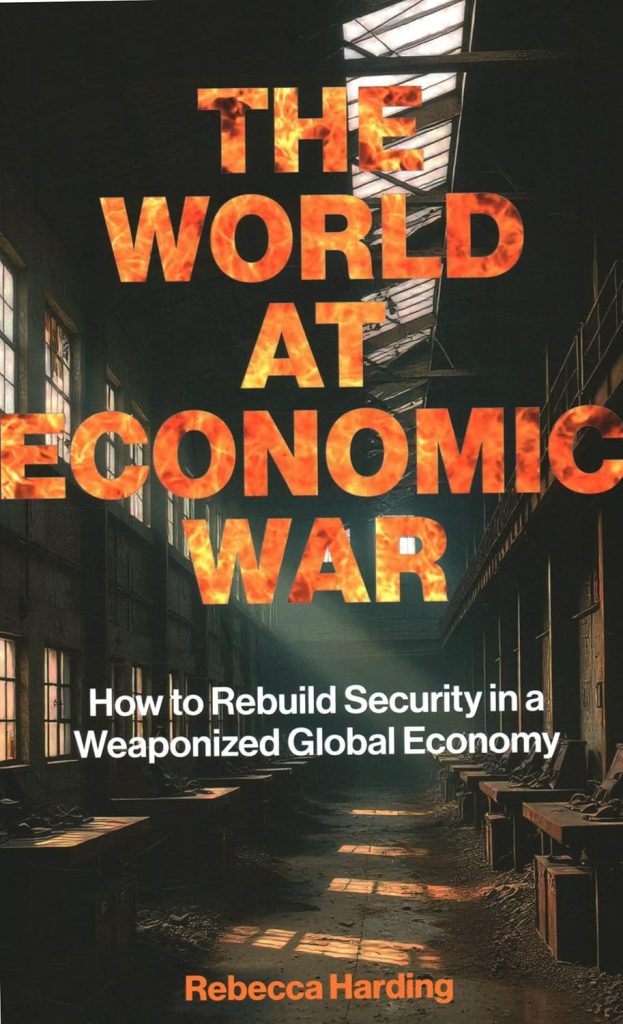

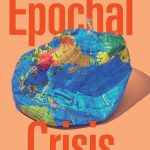
تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق